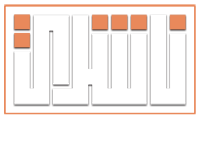إصلاح المجتمع يبدأ من إصلاح الفرد، وإصلاح الفرد يبدأ من إصلاح فكره أولاً، وهكذا كان سلف هذه الأمة، فكرهم يرتفع عن الترهات، ومقاصدهم تسمو على النجوم، ولا أدل على نبل تفكيرهم، وسمو مقاصدهم، وثاقب نظرتهم من خبر ذكره الجاحظ، قال: (نظر عثمان بن عفان رحمه الله إلى عير مقبلة، فقال لأبي ذر: ما كنت تحب أن تحمل هذه؟ قال أبو ذر: رجالاً مثل عمر). هذا خبر موجز، ولكن فيه مضموناً كبيراً، ودلالات بعيدة، فهو يهدينا إلى سر عظمة الأمة المسلمة، وهو ذلك الفكر القيم المستنير بمشكاة النبوة، والذي قاد رعاة الإبل والغنم إلى قيادة الشعوب والأمم.
فالفكر هو رصيد الأمم، وأساس تطورها، وعليه تقوم دعائم الحضارة، ومقومات المدنية، وعلى قدر ما يكون ذلك الفكر أصيلاً ونابعاً من تأمل وتجربة وعمق ومعرفة وواقع واتزان، بقدر ما تندفع هذه الأمة أو تلك نحو سلم الرقي والتطور، فإذا انسجم الفكر مع مكونات الإنسان الروحية والبدنية، والنفسية والواقعية، وتطابق مع الكون والحياة في التفسير والغاية، فإن هذا الفكر يكون مثالياً متسقاً من داخله، ويستطيع أن يحقق ما تطمح إليه عوالم الإنسان الداخلية من الخير والسعادة والحق والجمال، وهذا ما تحقق للأمة العربية بعد الإسلام، فقد استطاع هذا الدين أن ينقي العقل البشري من لوثات الانحراف العقدي والسلوكي، ثم قام بغرس قيم أصيلة عليا، هذه القيم قد تضحي بالعاجل ابتغاء الآجل، وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتقدس التضحية بالذات من أجل سعادة الآخر في مجتمع الحق والخير والقيم النبيلة.
لقد كان الجيل الأول من هذه الأمة جيلاً قرآنياًً فريداً، وموضع القدوة والقيادة في كل شيء ولا سيما في أفكاره وتصوراته، صحيح أنهم كانوا يؤدون العبادات ونحن نؤديها اليوم، ولكن شتان بين الأدائين، وشتان بين دوافع كل أداء. فنحن نقرأ القرآن ونسمع الأحاديث والمواعظ التي تحثنا على عدم الركون إلى الدنيا، وتقديم المصلحة على المبدأ، ومع ذلك فإن الدنيا تتربع على عرش القلوب، وتكاد الآخرة أن تُنسى: (كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ) (القيامة:20-21) .
لقد تسلط علينا وهم قاتل من حب شهوات الدنيا، وحرص شديد على جمعها، كل فرد منا يريد بناء حلمه الخاص، وتكوين عالم مستقل به، أشبه بمملكة صغيرة، يكون هو سيدها المطلق، ويحقق فيها ما تشتهيه نفسه، ولا يبالي بالآخرين، ولو كانوا يحترقون من حوله.
ومع أن الأرزاق مكفولة (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) (الذريات:22) ، وفي الأرض ما يكفي سكانها لو تضاعفوا عشرات المرات كما يذكر علماء البيئة والحياة، فإن الصراع القائم في هذا الكوكب الصغير مداره الأول والأخير على المادة والثروة، والتهالك والتنافس قائم على جمع الأموال من شتى السبل، ومن هنا تسقط الأمم، وذلك حينما يكون المال هو الغاية وليس الإنسان، ولا يتم ذلك إلا عندما يحدث فصام بين السلوك والفكر أو بين العقيدة والواقع، أو بين النظرية والتطبيق، ولا يشترط في سقوط الأمم وذهاب الحضارات أن يكون الفكر منحرفاً فقط، فلو كان الواقع منحرفاً، والفكر صحيحاً، فإن السقوط قادم ما لم يتم تحويل المبادئ إلى واقع مشاهد، ويكون هنالك ارتباط وثيق بينهما، لا ارتباط ترقيع ولا تلفيق على حد قول إبراهيم بن أدهم:
نرقِّعُ دنيانا بتمزيقِ ديننا فلا دينُنا يبقى ولا ما نرقعُ
رحم الله أبا ذر، فلو كان مكانه أي واحد من رجال عصرنا، لما تردد أن يقول لعثمان عند جوابه: كنت أود أن تحمل بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة.. ولكن هيهات أن يقول ذلك أبو ذر، وكيف يقوله وهو الصحابي الزاهد المتعفف الذي آثر الآخرة على الأولى، وازدرى حطام الدنيا طالباً رضوان الله تعالى. إنه يعيش في عالم أسمى، فهو يتمنى صلاح البشرية وإنقاذها، وصلاح البشرية لا يقدر عليه الضعفاء والمساكين، وإنما ينهض به الرجال الأمناء الأقوياء بالحق، الأشداء في مواجهة الباطل، الذين يعيشون عدلاً، ويقضون شهداء، أمثال عمر وبقية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
لقد كانوا يترفعون عن التفكير بالنفس فقط، ويتحررون من جغرافية الجسد والوطن، ويتجاوزون شهوات هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ليفكروا في تصحيح مسار الحياة الإنسانية، وذلك لا يتم إلا بنشر الخير وقمع المفسدين، والقصاص من الطغاة وإقامة العدل، ورفع لواء التوحيد فوق الثريا.
وماذا لو حملت قافلة برجال مثل عمر؟ هل كنت سترى جيوش المنكوبين والفقراء على وجه الأرض.. إنها أمنية عظيمة جدا، تمناها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يفكر في مشكلات الناس، فلا يرى حلا لها إلا بوجود رجال عظماء مثل عمر، حيث يعد عمر من أرفع النماذج الإنسانية الخالدة بين المسلمين وغيرهم.
ولكن أتراه يريد رجالاً مثل عمر في إسلامه؟ أم في هجرته؟ أم في صدقه وعدله؟ أم في زهده وحلمه؟ أم في خوفه من ربه؟ أم في جهاده واستشهاده؟ أم في صحبته وطاعته للرسول صلى الله عليه وسلم.
إنه يريد رجالاً مثل عمر في كل شيء، يتجسد من خلالهم معنى الإسلام، وجمال العدل، وعظمة الإيمان، وسطوة الحق، وصدق الجهاد، وسمو الأخلاق ورفعة النفس، وشفافية المعاملة ونبل المؤمن.
لقد كان هدف الصحابة رضي الله عنهم جميعا هو أن لا ينتكس الناس، فيعودوا إلى جاهلية قديمة، أو يخترعوا جاهليات جديدة، أاو يتقاعسوا عن نصرة دينهم، وأداء واجباتهم، أو يفرطوا في أماناتهم، وذلك ليستمر ركب الخير، ولا يقهره حزب الشيطان، فيزحف لسحق جند الهدى من جديد.
وماذا لو تمنى أبو ذر أن تحمل تلك القافلة متاعاً له أما كان ينفقه ليطعم به الجائع والمسكين والأسير؟ بيد أن أبا ذر وهو يدرك أهمية المال في غسل أحزان المعذبين في الأرض، يعلم أن هنالك ما هو أهم من المال، وهو الرجال الصالحون الذين يحافظون على ذلك المال، ويثمرونه، وينفقونه ليكون بلسماً للمحرومين، فيمسح عن عيونهم الدموع من أجل إسعاد العالم.
صحيح أن المال يُسكن جروح المحرومين مؤقتاً، ولكن رجالا ًمثل عمر بإمكانهم إسكات تلك الجروح بشكل دائم، فما أسرع ما يتلف المال أو يذهب بالنفقة، ويحتاج السائل إلى غيره من جديد، ولكن لو وجد العظماء أمثال عمر فإن عدلهم سيملأ الأرض، وسترفرف أعلام الجود في كل مكان، وستبقى سيرتهم خالدة تعلم الإنسانية وتنير لها إشعاع الخير وطريق الهدى.
ولا قيمة في ميزان أبي ذر لمتاع الدنيا كله لو سيق إليه فيما لو سادها الظلم والفساد، حيث إن الظلم في النهاية سيمحق الظالم والمظلوم، ويطال المعطي والمحروم، وينال الفاعل والمتفرج في الحياة، وهو مؤذن بذهاب العمران، وهلاك البشر، فلا قيمة للحياة مع الظلم حتى ولو اجتمعت للمرء كل أسباب السعادة والرفاه، طالما لم يقم عليها الشرفاء، ولم يحكمها الأمناء مثل عمر، وهذه هي المصلحة الحقيقية لأبي ذر وغيره، ولذلك رغبها أبو ذر بدلاً من المصالح الزائلة التي يتهافت عليها أهل الدنايا من البشر، أولئك الذين يحطمون مصالح الآخرين من أجل مصالحهم، ويبنون أمجادهم من عرق الكادحين وجوع الفقراء والمساكين، فيتمنون أن تصب الدنيا كنوزها في جحورهم، فما أبعد أولئك عن منهج أبي ذر؟ ذلك المنهج الذي يتلمس صلاح البشرية في قادة مخلصين عادلين يقيمون منهج الله في الأرض بكل صدق وإخلاص وعزيمة، وفي هذا صلاح لأبي ذر وغيره من سكان العالم.
واليوم بعد أربعة عشر قرناً من إشراقة الإسلام لو سألت أي عاقل عن أمنياته لحدثك كثيراً عن أشياء لا تتجاوز إطار الماديات بما فيها من إغراء ومتاع، ومن هنا تقهقرت الإنسانية وبان عجزها وفشلها، تهافت في الفكر، وانحراف في السلوك، وتبعية وكسل عند بعض الأمم، وظلم وطغيان عند بعضها الآخر، ولا أتصور هذا الخراب الذي دك معاقل أمتنا على وجه الخصوص هو خراب صوري، بل هو خراب جذري جاء نتيجة لسبب مهم وهو خراب الإنسان من داخله، وبالتحديد من خراب الأفكار أو من سوء ترتيبها، فالواجب على المهتمين بإصلاح الإنسان وبناء الأوطان في عالمنا الإسلامي أن يهتموا بشكل قوي وفعال ببناء العقل المسلم، وصياغة الفكر عند شباب هذه الأمة، وذلك حسب القواعد الخلقية والقيمية لهذه الأمة، مبتعدين عن الخرافة والأساطير، فقد كان النبي محمد عليه السلام وهو القدوة والأسوة رائدا في ذلك، روى المغيرة بن شعبة، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى تنجلي).
وينبغي الاستفادة من أهم أسلحة العصر وهي العلم والمعرفة، ومن خبرات الأمم والشعوب في شتى الميادين، ليكون لدى الإنسان بصيرة قوية من داخله تحصن من الوقوع في مستنقع الضلال.
ونقول في الخاتمة:
أيتها الحياة الجميلة بما فيها من مفاجآت وتقلبات.
أيتها الدنيا الحلوة حيناً والمرة أحياناً
أيتها البشرية التي تجنح للملائكة مرة، وللشياطين ألف مرة.
أيتها العيون التي تنتظر بسمة الفجر من وراء جلابيب الظلام.
أيتها القلوب التي ترتعش أحلامها في عالم الرعب والحرب.
لا تنتظروا من جحافل الظالمين وقفة عدل، ولا تتهافتوا على أهوائكم تهافت الجراد على الزرع، وعليكم إذا أردتم صلاح شأنكم والعالم من حولكم أن تنشئوا جيلاً أقدامه في الأرض وأحلامه في السماء، يفكر بالقيم والأخلاق قبل أن يفكر بالأهواء والشهوات، ويترفع عن سفاسف الأمور ومفاسد الأخلاق، فلا صلاح للحياة إلا بصلاح أهلها، ولا يصلح أهلها إلا بصلاح عقولهم وأفكارهم، ولا يتم ذلك إلا عندما نتبنى فلسفة رشيدة مثل فلسفة أبي ذر، وهي فلسفة تفكر بصلاح الإنسان والمجتمعات قبل أن تفكر في طعامها وشرابها، ولهوها ولذاتها.